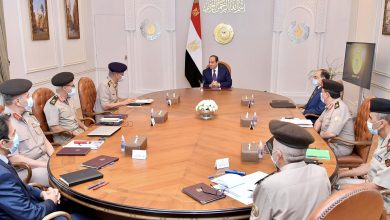وصف بعض المرشحين الفائزين فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب نتائج هذه المرحلة بأنها «صفعة على وجه 25 يناير 2011». ويأتى هذا فى سياق ما دأب عليه إعلام رجال الأعمال وممثلى أجهزة الأمن من القول إن ما حدث فى مصر فى يناير 2011 هو مجرد مؤامرة خارجية حرَّكتها مجموعة من الشباب الخونة المموَّلين من الغرب. وتجرى المقابلة من هؤلاء الإعلاميين وأشباه الساسة بين ثورتى 25 يناير و30 يونيو. ويعتبرون أن الأخيرة هى انقلاب على الأولى، وأنها هى الثورة الحقيقية. وهم يغفلون عن حقيقة أنهم بهذا يقدمون على طبق من ذهب شرعية ثورية للإخوان المسلمين، حيث يضعونهم فى سلة واحدة مع 30 مليون مصرى خرجوا فى كل مدن مصر لإسقاط نظام مبارك. وبصرف النظر عما تنطوى عليه هذه الأصوات من مخالفة للدستور- الذى هو مصدر شرعية النظام القائم، ومن إهانة لشعب مصر الذى خرج فى يناير، مطالبا بإسقاط نظام الفساد والاستبداد، ونجح فى إسقاط رؤوس النظام دون أن ينجح فى تقويض دعائمه وأركانه- فقد أثبتت المعركة الانتخابية البرلمانية الأخيرة حتى الآن أنها معركة حول الثورة وضد الثورة أو دفاعا عنها، انقَضَّت فيها القوى المضادة لثورة يناير للقضاء على رموزها.
وهذه كلها جريرة النظام الانتخابى الذى جرت صياغته أيام الرئيس المؤقت، وفصَّله خبراء تفصيل القانون على مزاج الهوى السياسى، وأيضا جريرة واضعى الدستور الأخير، الذين تركوا تشكيل معالم نظام انتخاب البرلمان فى يد السلطة التنفيذية. وكانت هذه هى المرة الأولى فى التاريخ الحديث، التى يترك فيها ممثلو سلطة التأسيس ولاية تشكيل السلطة التشريعية فى يد السلطة التنفيذية وليس العكس.
فى الحوارات الصورية التى كانت تعقدها الحكومة مع الأحزاب والتيارات السياسية حول قانون مجلس النواب، وشاركتُ فى بعضها، وَجَّهت أكثر من مرة سؤالا واضحا إلى رئيس الحكومة وإلى الوزراء المعنيين لم أتلق أبدا إجابة عنه، وكان السؤال كالتالى: ما شكل البرلمان الذى يريده المصريون بعد ثورتين؟ دعونا أولاً نتفق حول معالم المجلس النيابى الذى يُراد له أن يشرع لمصر، وأن يراقب السلطة التنفيذية فيها، وفى ضوء الإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نحدد معالم النظام القانونى الذى سيحكم تشكيل المجلس النيابى. لقد قامت فى مصر ثورتان لأهداف سياسية: الأولى لرفض سلطة الفساد والاستبداد وبيع الوطن لرجال الأعمال الفاسدين فى عهد مبارك، والثانية لرفض سلطة الفاشية الدينية التى كانت تعمل باسم الدين على التفريط فى وحدة الوطن وأمنه فى عهد الإخوان. بعد هاتين الثورتين الواضحتين فى أهدافهما، هل المطلوب أن يأتى برلمان يحقق أهداف الثورتين، أم برلمان يردع المصريين عن المطالبة بحقوقهم مرة أخرى؟ هل المطلوب برلمان يحقق التغيير الذى من أجله ثار الشعب، أم برلمان يحقق الاستقرار ويترك التغيير إلى مَن بيده أمر التغيير إن شاء أجراه وإن شاء جفل عن تبعاته؟
كان هذا هو السؤال. ولم تكن تُقدَّم عنه إجابة واضحة أو غير واضحة، بل الصمت والإضمار من أهل الصمت والإضمار والتدبير. كان الشعب فى تفكير، وكان الحكم فى تدبير.
ويبدو أن العقبة الأولى أمام النظام الجديد وأمام القوى والجماعات التى تضررت من ثورة يناير كانت تتمثل فى دستور 2014، الذى وُصف فيما بعد بأنه «كُتب بنوايا حسنة، وأنه دستور طَموح، وأن تنفيذه يحتاج وقتا»، رغم القَسَم على احترامه. هذا الدستور، ولأول مرة فى الدساتير المصرية بعد 52، يقيم قدرا من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فأصبح من حق الرئيس حل البرلمان بعد استفتاء الشعب، ومن واجب الرئيس أن يعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها على البرلمان للموافقة عليه. أصبح من حق البرلمان أن يسحب الثقة من الرئيس بإجراءات خاصة وبأغلبية خاصة بعد استفتاء الشعب، بدلا من الثورة عليه كما حدث مع محمد مرسى. لقد قام الدستور بتقنين فعل الثورة ولم يتركه للمبادرات العفوية. (هناك دساتير أخرى، كالدستور الألمانى، تعطى للشعوب حق اللجوء إلى القوة فى حالة مخالفة السلطة للدستور). هذا النظام الدستورى لم يكن ليتوافق مع المزاج السياسى للنظام الجديد ولا مع المصالح المتجذرة لدى فئات عريضة من القوى الضاغطة من أصحاب المصالح فى المجتمع: سواء هؤلاء الذين يعتبرون أن بينهم وبين الثورة ثأرا شخصيا، أو مَن مَثّلت الثورة تهديدا لمصالحهم فى الصميم. هؤلاء وغيرهم وضعوا هدفا من صياغة قانون مجلس النواب، يتمثل فى المطالبة بتعديل الدستور، لحرمان الشعب من سلطته الجديدة فى إقصاء الأحزاب السياسية، خاصة الثورية منها، عن البرلمان، واستئصال قدرتها على تكوين ائتلاف يستطيع أن يمارس اختصاصاته فى البرلمان فى مواجهة السلطة التنفيذية.
ومن عجب أن قانون مجلس النواب السابق كان يعمل على تقوية الأحزاب السياسية بأن جعل نصف البرلمان يُشَكَّل عن طريق القوائم الحزبية والنصف الآخر عن طريق النظام الفردى. وفى ظل القانون السابق نجحت أحزاب وليدة أنجبتها الثورة فى أن يكون لها تمثيل معتبر فى البرلمان. ورغم أن دستور 2014 ينص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية، ورغم أن هذا الدستور أيضا أعطى للأكثرية الحزبية سلطة تشكيل الحكومة، فقد جاء القانون الجديد لمجلس النواب ليفسح المجال واسعا للانتخابات الفردية وتهميش الأحزاب. وتفرغت قنوات فضائية بعينها للهجوم على الأحزاب ووصفها بـ«العجز السياسى»، وبدلا من أن يعمل القانون على تقوية هذه الأحزاب التى تُوصَف بـ«العجز» سعى إلى الإجهاز عليها.
هذه كانت الأهداف السياسية لنظام ما بعد 30 يونيو، وتلك كانت أدواته القانونية. وقد حذرنا مرارا عند مناقشة مشروع قانون مجلس النواب من أن مثل هذا القانون سيفتح الباب واسعا للمال السياسى وللعصبيات القبلية ولرموز الحزب الوطنى أن يتحكموا فى البرلمان القادم، ولم يستمع أحد، أو استمع أولو الأمر ولم ينصتوا. وبدا أن التعجل فى فرض الأمر التشريعى الواقع أصبح هدفا فى ذاته، حتى يأتى إلى مصر برلمان مغلول اليد عن مواجهة هذا الواقع، فصدرت مئات التشريعات، وبعضها غير دستورى، بالمخالفة لاعتبارات الضرورة المنصوص عليها فى المادة 156 من الدستور. ووُجد من رجال القانون المأجورين، الذين ابتُليت بهم مصر فى كل عصر، مَن يبرر ذلك.
استمع الجميع ولم ينصتوا أو أنصتوا ولم يفهموا أو فهموا والتفتوا عما فهموه عامدين، فماذا جاءت النتيجة؟
عرف الشعب الحقيقة. وبدلا من أن يشارك الشعب بنفس نسب مشاركته السياسية السابقة، عزفت الأغلبية عن الذهاب للصناديق. كانت نسبة المشاركة بعد الثورة تدور حول الخمسين فى المائة: فى الاستفتاء على الدستور أو تعديله أو فى انتخابات رئيس الجمهورية أو فى انتخابات البرلمان السابق، فإذا بها تتدنى إلى حوالى 20% فى الجولة الأولى من انتخابات البرلمان، أى أن حوالى أربعة أخماس الناخبين لم يذهبوا إلى الصناديق، ناهيك عن الأصوات الباطلة التى ارتفعت إلى حوالى 10%، فهل يمثل هذا البرلمان شعب مصر؟! والغريب أن رئيس لجنة الانتخابات بدلا من أن يقارن هذه النسبة المتدنية بنسب خروج الشعب إلى الصناديق فى الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان السابق، إذا به يزهو أمام الإعلام بمقارنتها بالانتخابات المزرية التى قاطعها المصريون لمجلس الشورى ولبرلمان 2005.
ما علينا.. كان المطلوب أن يأتى برلمان منزوع التوجه السياسى، عازف، بل عاجز عن استخدام صلاحياته الدستورية. وقد تحقق ذلك حتى الآن عن طريق الخطوات التالية:
1- إبعاد القوائم التى لا تبشر بالتصفيق السياسى كقائمة صحوة مصر عن حلبة السباق الانتخابى. وبدلا من أن تنفذ لجنة الانتخابات حكم القضاء بإعادة الكشف الطبى على المرشحين- الذين سبق أن أجروه وتكبدوا آلاف الجنيهات دفعوها مُرغَمين لخزانة الدولة، بدلا من أن تنفذ لجنة الانتخابات هذا الحكم بيسر، عملا بمبدأ «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا»- رفضت اللجنة أن تعطى القائمة مهلة أكثر من ثلاثة أيام لإنهاء إعادة الكشف الطبى، (الذى سبق أن أعلنت نفس اللجنة أنه لا لزوم له)، ورفضت اللجنة مقترح عدم تحميل المرشحين رسوما باهظة مضاعَفة. وكان بوسعها أن تفعل ذلك لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن قراراتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة، ولكنها لم تُرِد ممارسة هذا الإلزام فيما لا لزوم له من وجهة نظرها. وهكذا انفردت قائمة الدولة (فى حب مصر كما يريدونها)، والتى أعدها ممثلو الأمن، بكل مقاعد القوائم فى المرحلة الأولى، ويُتوقع لها ذلك فى المرحلة الثانية، لأنها انتخابات بلا منافسة. لقد انتصر أنصار الحب والولاء السياسيين على أنصار تفعيل الدستور والربط بين السلطة والمساءلة.
2- دخول المال السياسى والبلطجة السياسية من أوسع الأبواب، فاكتسحت أحزاب رجال الأعمال، الذين عقدوا اتفاقات غير معلَنة مع الدولة، واستُحدثت أحزاب لم يسمع عنها أحد، أُغدقت عليها الملايين من رجال الأعمال، وحصدت الأصوات بأموالها. وبرنامجها المعلن الوحيد هو تأييد ما تراه الدولة صوابا، فما رآه الحاكمون حَسَناً فهو عند هؤلاء حَسَن، ولا داعى للرقابة التى من أجلها شُرع البرلمان.
3- دخول رموز الحزب الوطنى الذى أفسد حياة المصريين طوال ثلاثين عاما إلى البرلمان، إما من خلال التخفى وراء أحزاب رجال الأعمال أو فى القائمة الوحيدة الفائزة صاحبة شعار الحب. وعدد أعضاء «الوطنى» الذين فازوا حتى الآن 83 نائبا، أى حوالى ثلث الفائزين، وميزتهم الوحيدة أنهم اعتادوا السمع والطاعة مقابل الحصانة، وتلك ميزة لا تُدانيها اليوم ميزة.
4- حقيقة أن هناك بعض الوجوه المشرقة التى تُعَد على أصابع اليد الواحدة دخلت البرلمان وسيُجلجل صوتها تحت القبة دون تأثير مثلما كان الأمر فى عصور سابقة. ولكن هناك وجوهاً مشرقة أخرى سقطت أمام رموز البلطجة والبذاءة وانتهاك الحرمات، فهل يمثل هذا البرلمان المصريين بعد الثورة؟!
إننى أدعو المصريين إلى أن يفرضوا إرادتهم الحقيقية فى المرحلة الثانية، فمصر لن تكون أبداً مفعولاً به على هذا النحو، وإلا فليدفع المصريون الثمن.
المصدر